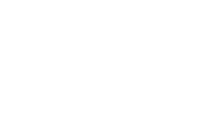وريثات الدم .. لماذا ارتبط وصول النساء الى السلطة بمعادلة دامية في الكثير من الحالات ؟

وريثات الدم .. صولانج الجميل سيدة أولى لمدة 20 يوما.. سونيا غاندي من ربة بيت إلى مناضلة.. وأكينو أشعلت «ثورة صفراء».
ارتبط وصول النساء الى السلطة بمعادلة دامية في الكثير من الحالات. فالكثير منهن وصل الى السلطة استكمالا لرسالة بدأها الأب او الزوج، الذي اغتيل او اعتقل في ظل صراع سياسي ما. بي نظير بوتو هي آخر «وريثات الدم»، لكنها لم تكن الاولى، فقبلها ورثت سونيا غاندي «عبء دم» زوجها راجيف غاندي الذي ذاق المر نفسه بعد اغتيال انديرا غاندي.
وتطول القائمة فهناك بهية الحريري ونايلة معوض ونايلة تويني وكوراسون أكينو وخالدة ضياء، وغيرهن كثيرات. ففي لبنان كانت اغتيالات قادة حملوا احلامهم ورؤاهم، وظنوا انها تقود البلاد الى بر الأمان، فاتحة لحقبات من اللاستقرار والفوضى المدمرة، وفي حين طوت الاغتيالات والاعتقالات السياسية مسيرة بعض هؤلاء القادة، الا انها كانت الحافز لبروز وريثات للبعض الآخر لم يجدن بديلا عن حمل الأمانة واكمال مسيرة الراحلين.
ومن بين هؤلاء صولانج الجميل، التي عاشت عشرين يوماً فقط «سيدة اولى» للبنان، بعد انتخاب زوجها بشير الجميل رئيسا للجمهورية عام 1982 غداة الاجتياح الاسرائيلي للبنان وخروج منظمة التحرير الفلسطينية منه. لكن مشوارها الرئاسي قوضه اغتيال بشير قبل ايام من تسلمه منصبه، لتصبح «الارملة الاولى» وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من عمرها.
وكانت الجميل قد انتسبت الى حزب «الكتائب» في الخامسة عشرة، وكونها ابنة الجراح لويس توتنجي أحد مؤسسي حزب الكتائب وكون بشير ابن الزعيم السياسي بيار الجميل، الذي أسس «الكتائب» وترأسها سنوات طويلة حتى وفاته، كان لا بد أن يجتمع بشير وصولانج بسبب الروابط العائلية، وكان الحب من النظرة الأولى الذي دام 11 عاماً وتكلل بالزواج عام 1977. باكورة الزوجين كانت الطفلة مايا التي اغتيلت بعد سنتين في محاولة تفجير سيارة لوالدها، كان يعتقد أنه موجود بها. ضمدت العائلة جرحها وتابعت مسيرتها في غمرة الحرب الاهلية. وفي عام 1980 انجبت صولانج يمنى، وقبل اغتيال زوجها بأربعة أشهر انجبت نديم.
بعد هذا المأساة غابت الجميل عن الواجهة السياسية من دون الابتعاد عن العمل السياسي والاجتماعي. فهي ان اعطت الاولوية لتربية ولديها يمنى ونديم، الا انها وبعد أسابيع على اغتيال زوجها أطلقت «مؤسسة بشير الجميل». رفضت الامتيازات التي تحصل عليها عادة زوجات رؤساء الجمهورية. لم تغير نمط حياتها المحافظ. ابتعدت عن كل المظاهر المرافقة للمناصب واكتفت بمكتب متواضع ومنـزل عادي في بيروت وآخر مثله في بكفيا (منطقة المتن ومسقط رأس زوجها).
قد ترتبط اسباب هذا الانكفاء بالظروف التي عاشها لبنان منذ اغتيال زوجها وما تلاه من انقلابات في الخارطة السياسية، وصولا الى اتفاق الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، وما استتبعه من معادلات غيبت قسريا الحضور المسيحي المعارض للوجود السوري وهيمنته المتزايدة على لبنان. ففي عودة سريعة الى تلك المرحلة نلاحظ ان عبارة «غير مرغوب بهم» وصمت القياديين المسيحيين، سواء عبر إبعاد العماد ميشال عون او نفي الرئيس أمين الجميل او سجن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع او اغتيال رئيس حزب الاحرار داني شمعون.
لكن الدم الذي ابعد صولانج الجميل عن الساحة السياسية، اعادها اليها. وذلك اثر اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، وخروج القوات السورية من لبنان ونشوء حركة «14 آذار»، التي فازت بأغلبية برلمانية في الانتخابات النيابية في صيف العام نفسه. وهكذا وصلت الى الندوة البرلمانية نائبة عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى. ورثت عبء الدم ايضا نائلة عيسى الخوري أو نائلة معوض، المولودة سنة 1940، التي بقيت سيدة اولى لمدة 17 يوما.
سعت منذ اللحظات الاولى التي تلت اغتيال زوجها الرئيس رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 الى ملء الفراغ الهائل، الذي خلفه لها وللوطن المثقل بحروبه الأهلية. فنائبة الشمال التي ولدت في عائلة سياسية عريقة وتزوجت ابن عائلة سياسية أيضا، لم تقع ضحية صدمة الاغتيال الذي يبدو أنها كانت تتوقعه. وكان رينيه معوض يتوقع هو الآخر أن يموت اغتيالا، فليلة الجريمة أوصى ابنه ميشيل، الذي بدأ نجمه السياسي يصعد إلى جانب والدته، بالعائلة وكأنه كان فعلا يودع الجميع. لا بل أن نائلة معوض نفسها حذرت زوجها الرئيس من الذهاب إلى القصر الحكومي، خصوصا بعد وصول تهديدات كثيرة إلى العائلة.

معوض التي مارست الصحافة لمدة عامين في جريدة «الأوريان»، أسست بعد وفاة زوجها «مؤسسة رينيه معوض» وتولت رئاستها. يكفي ان نسمعها وهي تتحدث عن نشاطاتها وانجازاتها لرفع المستوى المعيشي لأبناء الارياف في كل المناطق اللبنانية حتى ندرك الشغف الذي يحركها، ربما أكثر بكثير من ولعها بالسياسة التي دخلتها مكرهة بالاغتيال، فكانت نائبة في البرلمان اللبناني من عام 1991 حتى الان.. وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري تولت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوليو (تموز) 2005 في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. تميزت مسيرتها السياسية بحملها لواء المعارضة بأقل دبلوماسية مما كانت عليه مواقف زوجها، فكانت متمردة في تصريحاتها ومتمردة في البرلمان اللبناني. وكانت أول امرأة اعلنت ترشيحها لرئاسة الجمهورية.
اما نايلة تويني فهي أصغر «وريثات الدم» في مسلسل الاغتيالات وأكثرهن معايشة لهذا المسلسل. كأنه لم يكفها ان تكون ابنة النائب جبران تويني. وانما هي ايضا ابنة شقيقة الوزير إلياس المر، الذي تعرض الى محاولة اغتيال نجا منها بصعوبة. وايضا والدها الراحل هو ابن شقيقة الوزير مروان حمادة، الذي كانت محاولة اغتياله باكورة المسلسل بعد رفضه التصويت على التمديد لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود قبل ثلاثة أعوام، مع مجموعة نواب وضعهم جبران في الصفحة الاولى لـ«النهار» غداة التمديد على «لائحة الشرف».
بالكاد تجاوزت نايلة تويني الـ25 عاما من العمر، لكن طراوة عمرها لم تمنعها من قبول تحدي شغل مركز المدير العام المساعد لـ«النهار»، احدى أعرق الصحف اللبنانية. وذلك بعد الاغتيال المأساوي لوالدها النائب والمدير العام للصحيفة جبران تويني في 12 ديسمبر (كانون الاول) 2005. من هنا يمكن القول إن «المجد المهني» جاءها مكللا بالدم والحزن، وحملها مسؤولية لا تقتصر على امبراطورية اعلامية عمرها 73 عاما، ولها تأثيرها ليس في لبنان فحسب وإنما في العالم العربي كلّه. لم تقتصر تركتها على مملكة الاعلام وانما قيدتها بخط سياسي دفع والدها حياته ثمنا له.
نايلة بدأت خطواتها الاولى باتجاه هذه المسؤوليات، وهي كانت اختارت الصحافة مهنة قبل المأساة. بدأت كغيرها مرحلة تدربها ثم عملها في «النهار» منذ عام 2002، لكنّ الفجيعة التي حلّت بها وبالصحيفة أكسبتها نضجا مضاعفا. لم تكن تتمنى أبدا ان تصبح المديرة العامة المساعدة باجتيازها دروب الاغتيال الدامية. رغم صغر سنها لديها علاقاتها العامة مع جميع القوى والاحزاب السياسية في لبنان. لكن في الوقت ذاته تلتزم خط جبران السياسي وتحارب من أجله، لانها مقتنعة به وليس لانها وريثته.
حاليا لا تفكر في الترشح للنيابة. تعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا. لا تريد ان تحرق المراحل. لكن عندما يقترب الاستحقاق النيابي ستقرر في ضوء ما سيحدث. ولن توفر جهدا للقيام بكل ما تستطيع لوطنها. لن تتردد في خوض مغامرة التغيير من اجل الشباب. تلك المغامرة التي بدأتها إعلاميا من خلال ملحق «نهار الشباب» و«حكومة الظل الشبابية». وتختلف حكاية النائبة ستريدا جعجع المولودة عام 1967، زوجة قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تماما عن حكايات وريثات الدم. الاصح انها تشبه أكثر حكايات «الأميرة النائمة» او «سندريللا» او حتى «ليلى والذئب».
وعلى وقع كلمات الشاعر جبران خليل جبران «ولدتما معاً وتظلان معاً». زفت ستريدا طوق بتاريخ 20/11/1991 الى سمير جعجع ليعلن زواجهما بعد 4 سنوات من تعرفها إليه. آنذاك اقنعها بتغيير اختصاصها الجامعي من هندسة الديكور الى العلوم السياسية. كانت تدرك ان حياة زوجها على كفّ عفريت. كانت تتوقع أن يموت اغتيالاً. لكنها لم تفكّر يوماً بأنهما قد يمران بتجربة السجن والمحاكمات الطويلة التي لم تكن تعرف نهاية. لكن الأمر حصل وبعد ثلاثة أعوام من زواجهما أدخل «الحكيم» (لقب سمير جعجع) السجن، فانشغلت ستريدا عن نفسها بمسؤوليات ألقيت على عاتقها فجأة.
صارت زوجة سجين متهم باغتيالات وجريمة تفجير، زوجة رئيس حزب محظور. انعدم توازنها، خسرت أكثر من عشرة كيلوغرامات في شهر واحد. أدمنت المهدئات مدة ستة أشهر بعدما فقدت القدرة على النوم، كما قالت في احدى مقابلاتها. لم تكن تعرف طعم السيجارة. صارت تدخّن أكثر من علبتين يومياً. لكنها اقلعت عن التدخين قبل عامين. انفض عنها الاصدقاء الا قلة. لم يحبطها الامر. صمدت واعتبرت ان صمودها إلى جانبه مسألة أساسية بالنسبة لها وله. ابتعدت عن الاعلام مسافات طويلة وبقيت وحيدة مدة 11 عاماً. ناضلت بصمت وثبات لتحمي نفسها من الأخطار.
كانت تحت المراقبة، لذا تفهمت ابتعاد الناس عنها. قالت ان الناس كانوا يتجنّبونها كأنها مريض مصاب بالجذام! انضجتها التجارب وصقلتها، فتدرجت حتى انخرطت في الحياة السياسية بثقة عندما بدأ الطوق الامني يضعف بعد عام 2000. اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان عاملا مساعدا لتصبح داخل معادلة قوى «14 آذار». خاضت معركتها الانتخابية مع حلفائها في «تيار المستقبل» باسم زوجها سمير جعجع الذي كان لا يزال قابعاً في السجن. وقد تمكنت من الوصول الى الندوة البرلمانية، حيث صوتت على قرار اطلاق سراح زوجها وأرست نموذجاً مغايراً يمثل المرأة الانيقة الواثقة والقادرة على إثبات حضورها من خلال عزمها وتصميمها. لم تسلم الامانة الى سمير جعجع لتنكفئ بعد اطلاق سراحه، وانما لتتابع الى جانبه مسيرة لم تقوضها سنوات السجن. الشعور بالأمان هو عنوان المرحلة التي تعيشها حاليا معه.
وخارج العالم العربي لم تنج آسيا من «وريثات الدم» واشهرهن سونيا غاندي زعيمة حزب المؤتمر الهندي، فهي إحدى أبرز الشخصيات السياسية في الهند اليوم. وهي ايطالية الأصل دخلت ميدان السياسة على الرغم منها في أعقاب اغتيال زوجها رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي، حفيد جواهرلال نهرو مؤسس الهند الحديثة وأول رؤساء حكوماتها، وابن انديرا غاندي التي تولت أيضاً مرتين رئاسة الوزراء. ولقد قادت سونيا غاندي «التحالف التقدمي المتحد» في البرلمان الهندي (لوك سابها) حتى استقالتها في 23 مارس (اذار) 2006. وعاما 2004 و2005 اعتبرتها مجلة «فوربس» ثالث أقوى امرأة في العالم، بعد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ثم وو يي، وهي أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء الصيني.
انقلبت حياة سونيا رأساً على عقب بعدما سافرت إلى مدينة كمبريدج ببريطانيا لتعلم اللغة الإنجليزية، إذ التقت هناك براجيف غاندي وارتبطا بحب قوي، وتزوجا عام 1968 فانتقلت للعيش معه في الهند، لكنها لم تحصل على جنسيتها حتى عام 1983. ولراجيف وسونيا ولد وبنت هما راهول المولود عام 1970 وبريانكا المولودة عام 1972. ورغم اشتغال أسرة غاندي بالسياسة منذ زمن الاستعمار البريطاني، تحاشى راجيف وسونيا السير على الطريق نفسه. فقد اختار راجيف أن يكون طياراً مدنياً، وصرفت سونيا جهدها للعمل ربة منزل. وظلت بالفعل ربة منزل حتى بعدما اضطر زوجها لدخول معترك السياسة، بعد اغتيال والدته، ثم مقتل أخيه سانجاي الذي كان يفترض ان يخلفها، ومن ثم بلوغه القمة بتوليه رئاسة الحكومة.
ومجدداً، تغير مجرى حياة هذه السيدة الإيطالية الأصل، يوم 21 مايو (أيار) 1991 عندما فجعت باغتيال زوجها رئيس الوزراء الشاب في هجوم انتحاري نفذته امرأة من «نمور التاميل» في جنوب الهند. ومنذ وقوع الفاجعة تعرضت سونيا لضغوط هائلة من حزب المؤتمر لاعتلاء خشبة المسرح السياسي، فرفضت في البداية، لكنها أذعنت قبيل انتخابات 1998 وتسلمت قيادة الحزب، أي أنها أصبحت مؤهلة للمنافسة على رئاسة الوزراء. وبفضل وضعها كإيطالية الأصل تحمل اسم عائلة غاندي استطاعت ان تجتذب أعدادا كبيرة من المستمعين لحملاتها الانتخابية. لكن معارضيها، خاصة في حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي القومي المتطرف، استغلوا أصلها الأجنبي للتشكيك بولائها للبلاد فوصموها بأنها أجنبية تسعى لحكم الهند. وبالنتيجة خسر حزب المؤتمر تلك الانتخابات العامة، لكن سونيا تمكنت من دخول البرلمان وأصبحت فيه زعيمة للمعارضة. وفي سيرلانكا قصة دم أخرى، ففي عام 1960 دخلت سيدة سنهالية التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تتولى الحكم في نظام ديمقراطي خلال القرن العشرين.
السيدة اسمها سيريمافو بندرانايكه، التي انتخبت رئيسة لوزراء سيلان (سري لانكا اليوم)، المستعمرة البريطانية السابقة بأقصى جنوب شبه القارة الهندية. ولدت سيريمافو راتواتي دياس – باندرانايكه – يوم 17 أبريل (نيسان) 1916، لعائلة من الأغلبية السنهالية. وتزوجت في مطلع شبابها من السياسي اللامع سولومون بندرانايكه، الذي تحول أهله الأرستقراطيون إلى المسيحية الانغليكانية، قبل أن يعود هو إلى اعتناق البوذية.
ولقد تخرج سولومون في جامعة أوكسفورد في بريطانيا وتخرج محامياً وعاد إلى بلاده لينخرط في العمل السياسي عضواً في الحزب الوطني المتحد لمدة 20 سنة، ترقى خلالها وتولى مناصب وزارية. غير أنه انشق ومعه جناحه الحزبي عن الحزب المحافظ عام 1951 وأسس حزباً راديكالياً ذا توجهات سنهالية قومية أسماه «حزب سري لانكا فريدوم» (أي سري لانكا الحرية). وعام 1956 نجح سولومون باندرانايكه في قيادة حزبه الطري العود إلى السلطة على رأس تحالف مع ثلاثة أحزاب صغيرة، ملحقاً الهزيمة بالحزب الوطني المتحد العريق. وعلى الفور انتهج سياسة قومية سنهالية وجعل اللغة السنهالية لغة رسمية، مقللاً من شأن الإنجليزية والتاميلية، كما تبنى سياسيات اقتصادية ودولية اشتراكية مناوئة للغرب.
ولكن عام 1959 اغتيل باندرانايكه برصاص متشدد بوذي حرّضته جماعات دينية كانت ترى أن رئيس الوزراء لم يفعل ما فيه الكفاية لدعم مصالحها. وعلى أثر جريمة الاغتيال أسندت زعامة حزب «سري لانكا الحرية» إلى أرملته سيريمافو (التي كانت تصغره بـ17 سنة). ويوم 21 يوليو 1960 أصبحت سيريمافو رئيسة للوزراء وأول امرأة تتولى السلطة في دولة ديمقراطية، وانتهجت في الفترة الأولى من حكمها بين 1960 و1965 سياسة اشتراكية متشددة. لكن باندرانايكه لقيت منذ البداية تمرداً ومناوأة شديدة من الأقلية التاميلية. وبعدما خسرت الانتخابات التالية استعادت الحكم وتولّت رئاسة الحكومة مجدداً واحتفظت بالمنصب بين عامي 1970 و1977 وفي هذه الفترة غيرت اسم البلاد من سيلان إلى سري لانكا وأعلنتها جمهورية ذات سيادة كاملة منهية وضعيتها كدولة تابعة للكومنولث. وأكدت خلال هذه الفترة صلابتها ومقدرتها السياسية الفائقة.
غير أن اليمين تحت قيادة جونيوس جاياواردينه الزعيم القوي للحزب الوطني المتحد تمكن من إسقاطها وإبعادها عن الحكم في انتخابات 1977، مستفيداً من أزمة أسعار النفط العالمية في أواخر 1973. وبقيت باندرانايكه بعيدة عن السلطة حتى عقد التسعينات من القرن الماضي. إلا أن عودتها إلى الحكم للمرة الثالثة جاءت في ظل الزعيمة الجديدة للعائلة.. وهي إبنتها تشاندريكا (باندرانايكه) كوماراتونغا. فبعدما تمكنت لفترة طويلة من احتواء طموح كل من ابنتها تشاندريكا وابنها أنورا لخلافتها في الزعامة السياسية ـ ويقال إنها كانت تلعب على تناقضات مصالحهما وتنافسهما ـ خسرت المعركة أمام تشاندريكا التي تمكنت من فرض نفسها زعيمة للحزب، ومن ثم قيادته للفوز في انتخابات عام 1994 وتولّي منصب رئاسة الحكومة. غير أن الأخيرة أجرت تغييراً دستورياً حوّل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، وبعدما صارت تشاندريكا رئيسة للجمهورية أسندت منصب رئاسة الحكومة لأمها العجوز، وهكذا بعد سنوات طوال عادت باندرانايكه إلى رئاسة الحكومة لتحكم تحت سلطة ابنتها رئيسة الجمهورية حتى عام 2000، وهو العام الذي توفيت فيه يوم الانتخابات العامة.
وقد أسلمت الروح في أعقاب إدلائها بصوتها لآخر مرة، بعيد بضعة أشهر من مغادرتها المنصب. مسيرة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة تحمل في طياتها «عبء الدم». فقد تولت الشيخة حسينة، المولودة في 28 سبتمبر (ايلول) 1947، رئاسة الوزراء في بنغلاديش من عام 1996 حتى 2001. وتولت أيضا زعامة حزب «رابطة عوامي» (رابطة الشعب)، أكبر أحزاب البلاد السياسية، منذ عام 1981. وهي أكبر خمسة أبناء للشيخ مجيب الرحمن الزعيم الوطني وأول رؤساء بنغلاديش.
بدأت حياة الشيخة حسينة السياسية على مقاعد الدراسة بكلية إيدن النسائية في مدينة داكا، عاصمة باكستان الشرقية يومذاك، خلال عقد الستينات من القرن الماضي. لكنها كانت تعيش تحت ظل ابيها، الى ان قتل مع أفراد اسرته في انقلاب عسكري دموي في 15 أغسطس (اب) 1975. وكانت هي وشقيقتها الشيخة ريحانة الناجيتين الوحيدتين لمصادفة وجودهما في المانيا الغربية حينئذ. ومن ألمانيا انتقلت حسينة الى بريطانيا، ثم الى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث انتخبت رئيسة لـ«رابطة عوامي»، قبل السماح لها بالعودة الى البلاد والحياة السياسية في 17 مايو (ايار) 1981.
بيد أنها بعيد عودتها شهدت بنغلاديش ـ كما صارت باكستان الشرقية تعرف بعد استقلالها عن الشطر الغربي ـ مقتل الرئيس العسكري السابق الجنرال ضياء الرحمن في انقلاب عسكري آخر في الشهر نفسه. والعام التالي استولى الجنرال حسين محمد إرشاد على السلطة في انقلاب ابيض وأعلن الأحكام العرفية.
وعام 1983 قادت حسينة تحالفاً من 15 حزباً بغرض إسقاطه، فأمضت فترات عديدة خلال الثمانينات داخل المعتقل. وفي الفترة اللاحقة أدى حزبها مع «حزب بنغلاديش القومي» اليميني بزعامة البيغوم خالدة ضياء، أرملة ضياء الرحمن، دورا اساسيا في التصدي لحكم العسكر. لكنها دفعت الثمن بتكرار اعتقالها وحبسها سواء في السجون او قيد الإقامة المنزلية. لكن هذا النضال أتى ثماره عام 1990 عندما نجح تحالفها مع سبعة أحزاب أخرى في إسقاط حكومة إرشاد. ومن مفارقات الزمن ان «رابطة عوامي» تحت زعامتها تحالف مع حزب «جاتيا» (أي الوطن) الذي أسسه الجنرال إرشاد عام 2006 في محاولة لإسقاط حكومة خالدة ضياء.
وشهد عام 1991 اول انتخابات عامة في بنغلاديش بعد حكم العسكر الطويل، ففاز بها حزب بنغلاديش القومي ـ مع حلفائه ذوي التوجهات الإسلامية والمحافظة ـ وأصبحت خالدة ضياء أول رئيسة وزراء للبلاد، وصار حزب «رابطة عوامي» اكبر احزاب المعارضة. غير أن المعارضة اتهمت خالدة بتزوير الانتخابات. وهو أمر تكرر في انتخابات عام 1996 التي قاطعتها الاحزاب كافة عدا حزب خالدة، ففاز بها من دون منافسة. لكنه اضطر ـ بسبب غياب المعارضة في البرلمان ـ لإعادة الانتخابات بإشراف حكومة انتقالية.
وهذه المرة فاز حزب «رابطة عوامي» بـ148 مقعدا وصارت حسينة، بفضل تحالفاتها، رئيسة للوزراء. ورغم انها سعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فقد حالت الهوة الواسعة بين «رابطة عوامي» وحزب بنغلاديش القومي، المدعوم من بعض مراكز القوى في الجيش، دون ذلك.
وقد تعرضت الشيخة حسينة في فترة حكمها لسيل من الاتهامات بالفساد والمحسوبية ومحاولة السيطرة على وسائل الإعلام والتساهل أمام ما سمي بـ«التحرشات الهندية بسيادة البلاد». وحقاً، في آخر سنوات عهدها أعلنت منظمة «الشفافية الدولية» بنغلاديش «الدولة الأكثر فساداً في العالم». وكان الثمن الذي دفعه حزب «رابطة عوامي» فادحا في انتخابات 2001، إذ حصل على 62 مقعدا فقط مقابل أكثر من 200 لحزب بنغلاديش القومي وحلفائه، أي أكثر من أغلبية الثلثين المطلقة. وفقدت حسينة نفسها مقعدها المضمون سابقاً في رانغبور. وفي 2 سبتمبر قبض عليها مجددا بعدما اتهمتها «لجنة مكافحة الفساد» بتلقي رشوة في مشروع لبناء محطة لتوليد الكهرباء عام 1997. ويذكر ان غريمتها خالدة ضياء نالت المصير نفسه بعدما اتهمتها اللجنة بالفساد ايضاً.
ولا تختلف قصة خالدة ضياء كثيرا، فقد ولدت البيغوم خالدة ماجومدر يوم 15 أغسطس (آب) 1945 لأبيها رجل الأعمال اسكندر ماجومدر وأمها طيبة ماجومدر، وذلك في مقاطعة ديناجبور، بشمال غرب بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقاً). وعام 1960 تزوجت من الضابط ضياء الرحمن، الذي كان من أبطال حرب التحرير وأسس «حزب بنغلاديش القومي» المحافظ عام 1978 وصار رئيسا للبلاد.
ظلت خالدة بعيدة عن المسرح السياسي والحياة العامة حتى بعد صعود زوجها ضياء الى السلطة عام 1975، واختارت الاكتفاء بدور ربة المنزل وتكريس وقتها لتربية طفليهما. إلا أنها بعد مقتل ضياء يوم 30 مايو (ايار) 1981 في مدينة في تشيتاغونغ (ثاني كبرى مدن البلاد) أثناء محاولة انقلاب عسكري فاشلة، تولى الرئاسة بالوكالة نائبه القاضي عبد الستار، الذي تولى أيضاً زعامة "حزب بنغلاديش القومي. ولكن لم تمض على انتخابات نوفمبر 1981 الرئاسية أربعة أشهر، حتى أطاح رئيس هيئة الأركان الجنرال حسين إرشاد حكم عبد الستار وحزبه، ثم أعلن الأحكام العرفية في 24 مارس 1982.
وفي العام التالي، تحديداً، في مارس 1983 عين عبد الستار خالدة نائبة لزعيم الحزب. وفي فبراير (شباط) 1984 تولت الزعامة بالوكالة اثر تقاعد عبد الستار عن الحياة السياسية، ثم انتخبها الحزب زعيمة له في أغسطس من العام نفسه. وفي 27 فبراير 1991 أجريت انتخابات عامة، وصفت بأنها نزيهة، فاز بها «حزب بنغلاديش الوطني» وأصبحت خالدة أول رئيسة وزراء للبلاد. وقد أحرزت إبان سنوات حكمها تقدما ملحوظا في مجال التعليم، إذ خصصت له ميزانية ضخمة جعلت الابتدائي منه إجبارياً مجانياً (بما في ذلك الوجبات).
وما زال الكثيرون حتى اليوم يتذكرون اول رئيسة في الفلبين وهي كوراسون أكينو، التي كافحت في صفوف المعارضة الفلبينية بعد اغتيال زوجها على يد اجهزة الامن في حكم الديكتاتور فرديناند ماركوس. ترأست ماريا كوراسون كوجوانكو أكينو، الشهيرة تحبباً باسم «كوري» أكينو، الفلبين من 1986 إلى 1992 وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في بلادها. بيد أن هذا الإنجاز تحقق إثر محنة فقدها زوجها السناتور بنينيو أكينو، الشخصية الديمقراطية ذات الشعبية الواسعة، الذي كان أبرز معارضي ديكتاتورية ماركوس. أدت الجريمة إلى التفاف الشعب الفلبيني، وكذلك عدد من كبار أعوان ماركوس السابقين، حول الأرملة وثورتها الديمقراطية «الصفراء»، وانتهت الثورة بانتصار أسقط